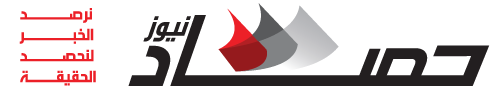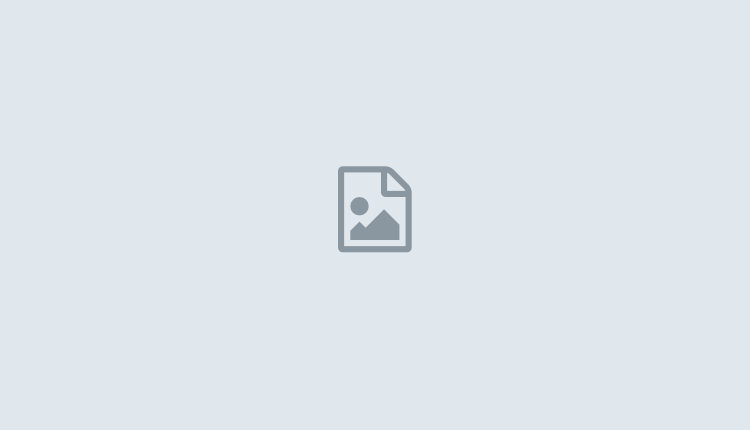الأردن ينجو من انهيار محتّم: رسالة ملكية وشيكة من الملك عبدالله الثاني إلــى بشار الأسد

السياسات الداخلية التي اتبعتها الحكومة الأردنية في العام الحالي، ساهمت، بدور أساسي، في الوصول بالاقتصاد المحلي إلى حافّة الهاوية؛ فهي اختارت، من جهة، نهج الخضوع للبرنامج الانكماشي لصندوق النقد الدولي وتوسيع الجباية ورفض برامج التنمية البديلة، بينما عمدت، من جهة أخرى، إلى التهويل بمخاطر الكيماوي السوري لتبرير الحضور العسكري الأميركي المتزايد، بما في ذلك استقدام الباتريوت وطائرات الأف 16 والجنود، تحت عنوان «مساعدة الأردن على مجابهة خطر الأسلحة الكيماوية». وقد خلق هذا التهويل، بحد ذاته، مناخاً انكماشياً، وسط انتشار واسع لمشاعر القلق والتحسب من التورّط الأردني في الحرب السورية.
الكآبة التي عمّت المملكة، نجمت، بالأساس، عن الإحباط إزاء التطورات التي كشفت أن النهج النيوليبرالي المضادّ للتنمية الوطنية بقي جاثماً ـ رفقة سياسات مالية متقشفة و متشددة ـ على رغم سنتين من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في العامين 2011 و2012، كما فضحت حالة الضعف والتبعية السياسية إزاء التحالف الأميركي ـ السعودي الذي أطاح الحياد الأردني نحو الحرب السورية.
وكان هذا الحياد، المشوب، أحياناً، بالحدّ الأدنى من التدخلات المؤقتة، الخلفية الرئيسية لقيام نوع من التوافق الداخلي لصيانة المملكة من آثار التورّط في سوريا. إنما كان ذلك، قبل أن تتولى السعودية، الملف السوري. لكن، بعد ذلك، أصبحت عمّان تحت ضغوط مزدوجة من الرياض وواشنطن، بما لا تحتمله بنية النظام الأردني. وإذا كان سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، قد بعث الثقة بالذات لدى مطبخ القرار الأردني، ودفعه لأن يكون أقلّ حساسية إزاء المعارضة ـ التي استُند إليها في مواجهة المشروع الإخواني المحلي ـ، فإن تلك كانت لحظة أوهام ومغامرة غير محسوبة؛ فقد بدأت المزدوجة الشريرة للفقر والسلفية، تعمل بسرعة على تقويض أركان الدولة، وتهددها بمصير الفوضى.
الشقّ الأول من تلك المزدوجة الشريرة، أي تعميم الإفقار وتهميش الريف، صنعه النظام بإصراره على المضيّ قدماً في السياسات الاقتصادية لحقبة الخصخصة واقتصاد السوق المعولم، رفقة البرنامج التقشفي الصندوقي. أما الشق الثاني من تلك المزدوجة، فيعود إلى الخضوع الإجباري للسياسة السعودية التي جمّدت سيرة أمنية أردنية طويلة في مكافحة الإرهاب، لمصلحة غض الطرف عن نشاطات التيار السلفي التكفيري في البلاد. وكمنت المفاجأة الخطرة في نموّ غير مسبوق لهذا التيار الإرهابي الذي أرسل نحو 600 من عناصره إلى سوريا، وسط غض البصر عنهم وعن انتشار التحشيد المذهبي.
ليس في الأردن شيعة، وإن كان العديد من الفولكلوريات الشيعية لا يزال في صلب الثقافة الشعبية لشرق الأردن الذي يضم أهم مقامات الصحابة. والتديّن الأردني، تقليدياً، متسامح وشعبي، وتدمج البنى العشائرية والجهوية، المسلمين السنّة والمسيحيين، بروابط تعلو على الانتماء الديني. بالمقابل، إن ذاكرة الأردنيين التقليدية تنظر إلى الوهابية بوصفها «ديناً غريباً» لعشائر صحراوية اعتادت غزو الديار الأردنية ونهبها حتى منتصف عشرينيات القرن العشرين. لكن هذه الوقائع التي طالما شكلت مصداً قوياً أمام التحشيد الطائفي والمذهبي، تراجعت اليوم تحت تأثير الإخوان المسلمين والسلفيين.
التناقضات التي شهدها الأردن في عام 2013 عديدة، لكن أسوأها اتباع سياستين: فمن جهة نظمت عمّان مؤتمراً للتقريب بين المذاهب، وآخر للبحث في أحوال العرب المسيحيين والحيلولة دون تهجيرهم، ومن جهة أخرى، غضّ الطرف، وأحياناً تشجيع الاتجاهات المذهبية والطائفية، لخلق مناخ يقبل بالحرب على سوريا، ويقبل بما يحدث في سوريا من عدوان التكفيريين على العلويين والشيعة والمسيحيين.
وصلت الاحتجاجات الاجتماعية، في الأشهر الأخيرة، إلى القلب العميق لمؤسسات الدولة الأردنية، وكان يمكن أن تتعرض المملكة، إن تورّطت في الحرب على سوريا، إلى تفاعل المصاعب المعيشية والاتجاهات التكفيرية والتغذية الإرهابية الراجعة والصراعات الطبقية والانشقاق بين المدينة والريف والأردنيين والفلسطينيين، ما يؤدي إلى التفكك والفوضى.
كان الأردن على الحافّة فعلاً، حين أنقذته التسوية الروسية الأميركية حول سوريا، إنما ظل يواجه تحدي تكوين سياسات جديدة، تجري مناقشتها اليوم في أوساط البيروقراطية الأردنية والدولة العميقة، وترى (1) ضرورة التواصل الفوري مع دمشق وبغداد وطهران وقوى 8 آذار في لبنان، والتوصل إلى تفاهمات تكفل عدم وقوع الأردن في فراغ استراتيجي تستغله إسرائيل لفرض مشروع الوطن البديل، (2) تحييد العامل السعودي عن التأثير الداخلي، والشروع في البحث عن بدائل لدعم الاقتصاد الأردني لدى بغداد وطهران (3) إقصاء التيار المعادي لسوريا من الحكم، وتشكيل حكومة صديقة للشام، وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة، مرحلة التسويات الكبرى في الإقليم.الاخبار